قراءة في مجموعة
هذيان ميت
للكاتب: زياد أبو لبن
( هذيان ميت ) للأديب زياد أبو لبن، حيث تتمحور جل أحداثها في رسم مشهد الشقاء والحرمان بأسلوبه الساخر والجاد لشخصيات مجموعته، كما هو الحال في قصته التي منحت المجموعة عنوانها.
"... تنبّه إلى صوت خلف منزله الذي لم يغادره منذ عشر سنوات، كان صوت خشخشة أشبه بحركة قطط تبحث عن قطعة لحم، فلم يصدّق أذنيه، لأنه لم يأكل اللحم منذ سنوات طوال، كان يعيش على النبات، ويفاخر بين أصدقائه ومعارفه بذلك... ".
يأخذنا الكاتب بأسلوبه السلس ولغته العذبة في رسم المشهد، حيث يضع القارئ في نفس القالب السردي ليعيش الحدث بطريقة متأنية في تشرّب العذاب والإحساس بالفقد والحرمان من خلال نصه، ثم ما يلبث أن ينتهي حتى يجد نفسه أمام همّ أكبر من تلك الأحلام التي تداعب رأس البطل حتى وصل به اليأس إلى العزوف عن الزواج، وتطرق الكاتب لشريحة كبيرة ومهملة في المجتمع، فئة المبدعين وطمر أحلامهم ووأدها في المهد، حيث يشّبههم بأبي العلاء المعري في محاولة منه لإحياء التراث الذي كاد أن يندثر بقوله " طاق طاق طاقية " وبروز التصوير الفني الجميل.
"... يذكر عندما طاف أرض الخليج، يدرّس تلاميذا صغارا، يراهم مثل أبنائه الذين لم ينجبهم في حياته، حتى إنه لم يتوقف عن لعب الكرة معهم في ساعات الفراغ، وفي أحد الأيام أثار ضحك زملائه عندما لعب معهم " طاق طاق طاقية "، وفي المساء يسير على رمل الصحراء حافي القدمين، يلامس حبات الرمل، ويحسّ بلسعتها في حرّ الصيف، وبردها في صقيع الشتاء، وكثيرا ما كان يتتبع سرب نمل في ظل شجرة شوكية يابسة، وفي صبيحة يوم لم يذهب إلى المدرسة، فزع زملاؤه من تغيبه، حسبوه مريضا أو أنه فارق الحياة، أو أن الحياة فارقته... "!
أسلوب التشويق كان حاضرا حيث جعل المتلقي يركض وراء الحروف لاهثا، دون منحه فرصة للتوقف، حتى يصل " القفلة " فيجدها مدهشة صادمة.
"... المهم أنهم أفرجوا عن كتبه وأوراقه التي خضعت للتحقيق أيضا، وفي ليلة سهرها حتى الصباح، حمل كتبه وأوراقه وسار فوق الرمل المحترق في آب، وقف تحت تلك الشجرة اليابسة، وضع الكتب في ظلها وحرص على ترتيبها، وأخرج مسدسه وهو يطلق الرصاصة تلو الأخرى، وهو يقول: هذا المعرّي وهذا المتنبي وهذا شوقي وهذا... وهذا، إلى أن نفدت الرصاصات إلاّ واحدة، وصرخ بأعلى صوته، وهذا أنا!... ".
يعود الكاتب بذاكرته إلى الوراء في نصه ( قبل عشرين عاما ) لمرحلة أليمة من حياته، بتصويره المشهد بحرفة، من صياح وهتاف ودخان قنابل الغاز وزملاء الدارسة وخيبته فيهم والمخيم الذي لا يزال عالقا في ذاكرته...
"... كان يسمع صوت المظاهرة من بعيد، يصيح بزوجته: أسرعي كي نلحق بهم، أخذ يقطع الطريق الترابي كي يختصر مسافة الشارع الملتوي كأفعى سوداء، اندس وزوجته وسط حشد تطاولت فيه أعناق الجميع، وهتاف يخترق صداه البيوت التي انتصبت كشاهد زور، دخان قنابل الغاز التي أطلقت في الفضاء مثل علب المشروبات الغازية... ".
ثم يصف مشهدا آخرا وسط دهشته بزميل دراسته الجامعية وتحوله عن المبادئ التي كانوا يعتقدونها...
"... نظر إلى صف من حاملي الهراوات لم يتبيّن من واقيات الرصاص ملامحهم، لكنه دقق النظر، فرأى "أحمد" الذي يحمل هراوة بيده اليمنى وواقية بيده اليسرى، لم يصدّق نفسه، وتساءل: هذا أحمد الذي كان يقود المظاهرات أيام الجامعة، هذا أحمد الذي كان يناقشهم في السياسة حتى تتدلّى ألسنتهم... ".
يبرز التصوير الفني في كل ما يريده الكاتب باختصار المسافات واقتضاب الجمل...
"... وقال لها: الآن أدركت لماذا نحن شعب الهزيمة؟!... ".
ينتهي النص بما أراد الكاتب بالتدليل على العنوان والمخيم واليأس والنهاية الأليمة لشريحة ممن يحملون شهادات جامعية، ثم يعلقونها على الجدار.
"... أدرك أن شهادته الجامعية قد علقها على جدار غرفته منذ عشرين عاما، وهي لا تختلف عن شهادة ميلاده التي لم يحتفل بها ولو لمرّة واحدة، عرف أن الذي يجمع الحياة والموت هو واو العطف، عندها قرر أن يعود إلى شوارع المخيم، ويدفع عربة صغيرة، وينادي بأعلى صوته: " شعر البنات سُكّر نبات "....
يعطي السارد المتلقي جرعة من الراحة وينقله من جوّ الألم إلى فضاء آخر ***بأسلوبه الخلاّب كما في نصه ( الأوغاد أيضا ) ونصه ( صيد ) بفلسفة رائعة وتشبيه جميل. ***
"... أخذ نفسا عميقا وجمع قوته في صدره، وشكل كرة من البصاق، ونفثها باتجاه بيت تربّع على جبل... ".
وأيضا في النص نفسه...
"... يذكر مشيتها، جلستها، كلامها، يذكر تفاصيلها غيبا، يذكرها أكثر من مادة "الصرف" التي انشغل أستاذه فصلا دراسيا كاملا يعيد تصاريف الأفعال... ".
وما جاء في نص صيد...
"... فيحتال على زوجته، ويشتري أرنبا من ذاك البدوي، ويربطه بخيط واهن تحت شجرة ملتفّة............... سأثبت لزوجتي أنني لست خائبا في الصيد، وهذا يكفيني شرّ نظراتّها، وسوف أمزق صدر الأرنب، فأين المفر أيّها ...؟! ويطلق رصاصة مدوّية، تقطع الخيط الواهي، ويفرّ الأرنب بعيدا...".
يعالج في نصه ( عزلة الصمت ) مشكلة اجتماعية واقعية مثبتا مهارته في تنوّع الحدث، ويبقي المخيّم حاضرا كشامة في نصوصه، رمزا شامخا، بألوان بيوته وجدرانه الكالحة، فهل كانت الحاجة سببا لأن تبيع المرأة متاعها"جسدها"؟ وهل يكون القهر والعذاب والمهانة سببا في تخلي المرء عن كرامته ومبادئه؟ حلم الفقراء واستغلال المرأة في العمل وقضيته والهروب من الواقع ما يضع يده عليه الكاتب وبإتقان...
"... لم تكد تمضي الشهور الأولى في عملها إلاّ وقرار إنهاء خدماتها يحطّ فوق مكتبها...".
"... كانت عيونهم تنهش لحمها الأبيض...".
وحضور القضية... ***
"... فقدنا الأرض خلف مجرى النهر، وهذا البيت تمتلكه وكالة الغوث، والمخيّم حلم الفقراء............ ***ولم يثنه التحقيق عن التمسك بقضيته التي لعبت بها أهواء السياسة كما كان يقول...".
تنتهي القصة بنهاية مؤلمة لـ "لارا" التي ساوموها على لحمها مقابل العمل..
" سعت إلى الموت بنفسها، وتصالحت معه عندما أطلقت على رأسها الرصاص، مضت بصمت، وبقيت الكلاب تطارد فتيات الشركة القابعة خلف ذاك الشارع ".
عبّر الكاتب في قصته ( عصف الذكريات ) عن حنينه إلى الماضي، عائدا بأوراق ذاكرته من جديد، فوحل المخيّم لا يزال عالقا بتلك الأوراق، وصدى صوت حلاق المخيم في الشوارع يرن في أذنيه، وصورة قريته ومخيم عين السلطان تنتصب أمامه كشبح لا يريم، ومطّهر الأولاد حاضرا بمقصه وآلته، وزغاريد النسوة التي تملأ حارته تدمي مقلته، وحمار "حكحك" العنيد.
إن استخدام الكاتب لبعض الكلمات الدارجة "الشعبية" زين النص وزاده جمالا، كقوله.."الحارة" و "هات شلنا" و" عريشة العنب" وغيرها من هذه العبارات الجميلة، وقد أظهر الكاتب براعته في سرد الأحداث وتفصيلها في مونولوج درامي متقن وجميل، مما يجعل المتلقي يرى الأحداث عن قرب كفيلم سينمائي، يعيشها بكل تفاصيلها الدقيقة، من ألم وفرح وبؤس وشقاء، فكان عصفا من الذكريات...
"... تلك الشوارع التي غاصت قدماه في وحلها حتى الرُّكب،، يا له من مخيم فقد ملامحه عندما اشتبكت أذرعه مع المدينة النائمة في حضن تلال لم تعد سبعا كما كانت... ".
"...وتعمل يد الحلاق حتى يأخذه النعاس، فيجزّ شعره، ثم يدفعه للأمام، ويقول هات "شلنا" يا أقرع...".
"... فالمخيم يشبه ملامح قريته التي لم يعد على خارطة الوطن الصغير سوى اسمها... "
حتى ينتهي به المقام لاجترار أحزانه وحنينه لكل تلك الصور، يطوف بذاكرته من جديد، فيشعر بمذاق مالح في أعلى جوفه...
"... ها هو ذا يعود إلى شوارع المخيم، يسير فيها غريبا، لم تعد تلك الوجوه التي رآها عندما كان صغيرا إلاّ في مقبرة المخيم، ولم تعد شوارع المخيم تغصّ بالوحل سوى طرقات إسفلتية سوداء، لم يعد للمخيم، حتى اسمه القديم وجود سوى في ذاكرة جيله، سار متجها نحو باب الحديد، لم يعد هناك باب، وإنّما مخفر شرطة أشبه بقلعة حصينة، سالت على خده دمعة ساخنة، وهو ينطلق بسيارته مسرعا... ".
ختاما...
كُتبت هذه المجموعة بأسلوب سردي حواري على لسان السارد "القاص"، حيث عبّر في قصصه عما يعانيه إنسان القرية والمخيم والشتات من قلق نفسي وضغط اجتماعي، يؤثر عليه نفسيا وفكريا، ويُبرزُ صورة القرية والمخيم بمشاهد متنوعة، كما صور الكاتب في قصصه الواقع المرير لإنسان المخيم، حيث أبرز ببراعة حجم معاناته النفسية والاجتماعية وكثرة ما يعتمل بداخله من ضغوط تجعله قلقا، متوترا ومكتئبا.
مما سبق يتبين لنا أن الكاتب نوّع في قصصه بين السرد والوصف والحوار، وذلك بغية خدمة المعنى وجعله واضحا في ذهن القارئ، إضافة إلى خلق نوع من التشويق والتنوير درءا للرتابة والنسق الواحد.
فيما يخص السرد، فالملاحظ في نصوصه أن عناصر القصة مرتبطة فيما بينها ارتباط السوار بالمعصم، حيث لا يمكن الفصل بينهما، وهكذا جاءت النصوص محبوكة ودقيقة التصميم.
هي سيرة ذاتية، وحياة عاشها الكاتب، فذاق من الشقاء ما يسع الكون، وحياة عانى فيها كثير من الناس ممن عايشهم، في شتاته من القرية إلى المخيم وإلى المدينة، فخرجت بقالب سردي جميل متين.
نشرت في جريدة الرأي الأردنية
خالد يوسف أبو طماعه
آخر المواضيع
|
|
|




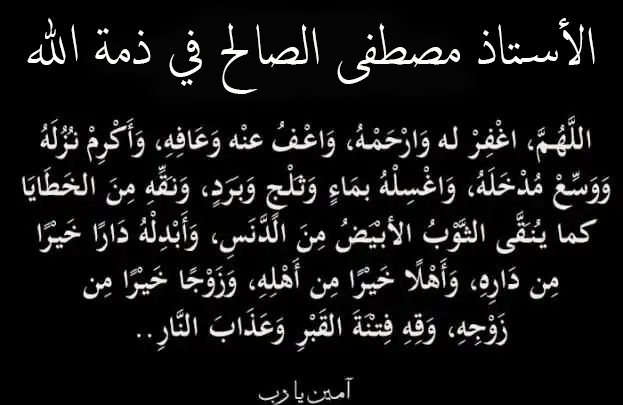





 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس